بهية طلب في «طرق فاشلة لاستعادة الأحبة»
تبادل الأدوار بين الصورة وظلالها
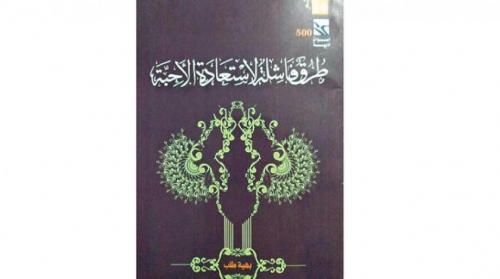
طرق فاشلة لاستعادة الأحبة
تشكل مشهدية الصورة الشعرية وعلاقتها بظلالها محور الرؤية في ديوان «طرق فاشلة لاستعادة الأحبة»، للشاعرة بهية طلب، الصادر حديثاً عن هيئة قصور الثقافة، بمصر. فكلا العنصرين، الصورة والظلال، يتبادل الأدوار، ويشتبك بسلاسة لغوية وفنية مع العالم والواقع والعناصر والأشياء، وكأنهما ظل لحلم هارب، تظل الذات الشاعرة تطارده، وتحاول الإمساك به، ولو في ظلال صورة متقلبة، صادقة حد الكذب أحياناً، مراوغة حد الإحساس بالوهم والضجر والفراغ أحياناً أخرى.
تبني الذات الشاعرة هذه الصورة من تناقضات واقعها المعاش الحي، بكل تفاصيله ومفرداته اليومية، بألفتها وقسوتها وحدتها، وبين الحين والآخر تحاول كسر عتمة هذا الواقع وضجره، ولو بالتماهي رمزياً مع أشياء تحبها، قريبة إلى النفس، تتجسد في غبار لقطات سينمائية لبطلات أفلام مشهورة، على سبيل المثال: ماجدة الصباحي وففيان لي، في فيلمي «أين عمري» و«ذهب مع الريح»، ومن قبل أنجلينا جولي، لكنها لا تكتفي بذلك بل تسعي إلى اللعب مع الصورة، وكأنها خيوط لزمن مثقل بمائه وخطواته. وعلى الرغم من ذلك، يتحرك بحيوية في فضاء النص، مشكلاً وعيه ولا وعيه، في صورته الماثلة بالديوان، وخارج إطارها أيضاً.
إذن، زمن الصورة في هذا الديوان هو زمن النص، وما تفعله الذات هو تفكيك الصورة وتحديد زواياها، واقتناص ملامحها القصية وإعادة تركيبها من جديد، في سياق رؤية ومشهد يضيق ويتسع، يقترب ويبتعد، لكنه في كل الحالات ابن الصورة وظلالها معاً.
نعم، تذهب الصورة، تنتهي كواقعة ومشهد حدث في لحظة ما، وتقفز ظلالها عرضاً فوق جدار الذاكرة، لكنها في هذه الديوان ليست مجرد فعل تذكر عابر؛ هي فعل معايشة بامتياز، لأنها ليست مستجلبة من حائط الذكريات فحسب، أو تتمسح في ظل فنون أخرى غالباً ما تضع للصورة إطاراً، وتوظفها لغرض بعينه، كالسينما والفن التشكيلي وغيرهما... الصورة هنا حية، متوترة، مفتوحة على الطبيعة والبشر، على البدايات والنهايات، هي إناء الروح والجسد، وقبل كل ذلك هي إناء الشعر، خلاصة اللذة والألم والفرح والمسرات، خلاصة الخيال... تخلقها الذات لتصنع مجد ضعفها وقوتها في النص الشعري.
هكذا تدير الشاعرة مناخات الصورة وتقلّبها في الديوان، ملوِّنة ظلالها ومشهديتها، على شتى المستويات الإنسانية، لكنها تظل ألصق وأدوم، كلما اقتربت من الفضاء الشخصي للذات، تومض في لحظات غيابها وحضورها، كاشفة عن المهمش والمسكوت عنه، القابع في الظلال، والذي تختلط فيه قسوة المحبة بقسوة الحياة.
فمن مشهد الجندي الذي يحرس جسراً في الحرب ولا يملك سوى قنينة ماء وبيادة وطريق، مروراً بمشاهد أقرب إلى روح الخرافة الشعبية، عن جنية الأسنان التي تترك سنتها تتحرك تحت الوسادة، ومسامرات الأم لابنتها الطفلة، وأفلام الكارتون، والملكة التي تتسلق البرج الشاهق بزينة عروس، متعللة بالبحث عن تمائمها الضائعة، وهي في حيرة من أمرها، لا تعرف حقيقة ما تريد، وكيف ستخوض باسم المحبة حربين معاً ضد حبيبها وأعداء القبيلة، وحسبما يقول النص:
«الملكة التي تسلقت برجكَ الشاهق بزينة عروس
وتعللت بالبحث عن تمائمها الضائعة
واحتمت بصدركَ
كانت تحفظ منطق الحرب جيداً
ليس عليها البدء بحربين معاً
حربِ محبتها لك
والحرب التي ستديرها غداً
ضد أعداء القبيلة».
لا تضع الصورة تمثيلاً نهائياً لظلالها، هي مجرد جسم، والظلال تفيض عنه، في فواصل ومسارات لا تفترض التطابق أو التشابه بينهما، فهنا ثمة ملكة عروس، وثمة برج شاهق تصعده تعللاً بالبحث عن أشياء ضائعة، وثمة حرب لها منطقها، وثمة حبيب، وثمة أعداء... تماماً مثلما في نص جندي الحراسة، ونصوص أخرى بالديوان. قد تبدو الدلالة أقربَ رمزياً لمظان السياسة، لكن في اللعب مع الصورة، دائماً ما تموِّه الشاعرة العلاقة بين الرمز ومرموزه، بل تغيّب أحد طرفي العلاقة، ليصبح حضوره أقوى إيحاء بطاقة الغياب والتخفي.
من ثم، فالصورة كجسم مكتفية بذاتها إلى حد كبير، وفي ظلالها كل شيء قابل للتأويل، لأن الظلال هي التي تمنح الجسم صفة الثبات والتغير، مثل الحجر، ثابت في مكانه، لكننا نحس بأن صورته تتغير كلما مر الظل عليه.
يبلغ اللعب مع الصورة ملمحاً شيقاً، حين توهمنا الذات الشاعرة بأنها تمارس نوعاً من الخدعة البصرية، حيث تتحول السخرية بشكل مباغت إلى سلاح للكشف والتأمل، والضحك إلى حد البكاء أيضاً... ففي أحد النصوص، تمازح صورة الموت، تدعوه لشرب فنجان من القهوة وتدخين سيجارة، والحوار الحر المكشوف بلا أقنعة، ثم تفاجئنا في نهاية نص آخر قائلة: «أريد أن أموت على مقهى».. تقول فيه:
«ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﻔض قطﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻦ جسدي
جسدي الذي ﺍﺣﺘﻠﺘﻪ ﻏﺎﺑﺔٌ
ﺗﻀﺤك ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﺍﺑيت ﺃﺻدﻗﺎﺋي
ﻣﺎ ﻫذﻩ ﺍﻟﺨدﻋﺔ!
ﺃﻛﺮﻩ أحذيتي ﺍﻟﺒﻠﻮﺭﻳﺔ التي تتكسّر
ﺣﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﻋﺔ
ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻮﻑ التي ﺯﻳﻨﺘﻬﺎ
ﺑﺄﺛﻮﺍﺏ عرسي ﺍﻟمطرﺯﺓ لحبيبي
الذي ﻗﺘﻠﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺻيف
ﻻ ﺃحب ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺢ
ﻭﻟﻦ ﺃﺻفف ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻤﺎء ﺛانية
ﺃﺻﺮﺥ: ﺃﺭيد ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻬﻰ»
وحين ترسم صورة لقلبها، تأتي الخدعة البصرية على نحو مباغت، كاسرة من خلاله اعتيادية الصورة ونمطيتها، وكأنها تشدنا من غفلة ما، كأن الصورة تكثيف لجذرية الحياة، تقول الشاعرة في نص خاطف:
«قلبي
كلما ألبسته رداء النوم
غافلني وخرج للمقاهي يدخن بشراهة
لاعناً الذاهبين والعائدين بأعلى صوته
ويقف في وسط الشارع داعياً العربات لتدهسه»
هذا الرجاء المخاتل الذي تخلفه الصورة، بهذه الرغبة الحادة المباغتة في الخلاص، يشي بوعي مخالف وضدي، يمكن أن نفتش فيه عن وعي آخر بالجمال، يتجاوز الواقع الطارد الضاغط، ويسمو عليه، في أقصى لحظات المع والضد، إنه شكل من أشكال إدراك الذات في الوجود والواقع معاً، كما أنه يمثل محاولة للتخلص، ولو باللعب في ظلال الصورة، من كل نوازع الملل والرتابة والتكرار التي تكسو الحياة. وهو ما تجسده الشاعرة ببساطة مشهديه ولغة سلسة، تعكس صورة الخارج على الداخل، في نص تقول فيه:
«قبل خروجي من البيت
أقف أمام مرآتي الضخمة
أجرب أشكالاً من الضحكات
والبسمات على وجهي
يا الله
أعطني مرة واحدة سعادة حقيقية
تعبتُ من إلصاق البسمات بشفتيّ».
يضعنا هذه النص أمام سؤال أساسي، يعكس حيرة الذات، ما بين ظاهر الصورة وباطنها، في الحياة وفي الشعر، بينما تبلع الصورة أوج فعالياتها، حينما تتحول إلى مرآة للنص، تنداح فيها تمثلات الذات كوجود، قابل للنقص والإضافة، للمحبة والكراهية، حينئذ يمكن أن تتمرد على الصورة وظلالها، بشكل صريح وواضح، فهي لا تريد أن تكون رجع صدى لأشياء بائدة، حتى لو كانت حميمية تحت مظلة العائلة.. تقول الشاعرة مجسدة هذا في أحد النصوص الشيقة في الديوان:
«لست واضحة الملامح في هذه الصورة
ولا في أي صورة أخرى
أنا خدعة ضوئية
أبتسم بحدة كحقيبة سوداء
وعندي ثلاثة وعشرون قلم روج أنسى أن استعملها
ولون شعري الأصلي بني فاتح
قالت أمي إني كالشتاء الذي جئت به
مع أنى الوحيدة التي كانت ترسلها لشراء الخضار وأعود بالقائمة مكتملة
وقال أبى إنى أشبه الرعد وأنا لم أغضبه سوى مرة أو مرتين
ولامني حتى موته لأني حذفت اسم محمد من اسمي
كلما تحسست وجهي أجد شظايا ذاكرتهم
وأخاف ألا أعرفني».
إن الخوف من عدم المعرفة لا يتعلق بهواجس الماضي المرتجفة فحسب، ولا بطبيعة الذات القلقة، ومقدرتها على أن تهشم المرآة والصورة معاً، إنما يتعلق قبل كل شيء بمقدرتها على أن تسائل نفسها، أن تحول رجع الصدى إلى رنين يخصها.. هكذا تحضر صورة الأب، وفي ظلالها يتحول النص إلى جرس، له تردداته وخوفه الخاص، فصورة الأب تكاد تكون الوحيدة التي تتطابق مع ظلها، ويعكس التمرد عليها قلقاً على الحياة، وحرصاً على التشبث بها، ولو في شكل دمعة ومرثية.. تقول الشاعرة:
«كنت أخاف أن أمر أمام عينيك ولا تعرفني
سيمزقني أنك لا تدرك أني ابنة عمرك
أنا بهية
أحمل اسم جدتي
ولكي أكف عن الصراخ أسميتني حنان
أنا هذه النافرة من قطيعك
بشعري المهوش
وحرائقي الدائمة
أينما حللت أصعق النجمات بغضبي
وأنت تبلل السماء
حيث إنها ستمطر
أستطيع أن أتهم المطر
وأبكي رحيلك».
هكذا تخدعنا بهية طلب بصورها وظلالها، ولا بأس أن توهمنا في ديوانها الممتع هذا بأنها «تجلس على أطراف الغابة، تراقب القرود، وهي تأكل قلبها نيئاً، والنمل يعيده».



