مراجيح الناثر بدر شاكر السيّاب لجاسم المطير..
دمامة اللغة بعيداً عن وهج القصائد
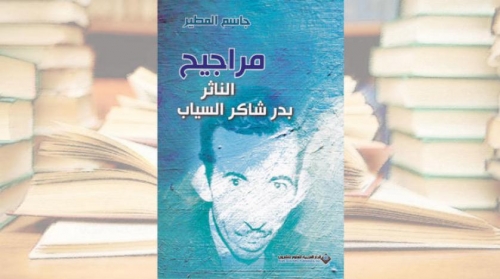
كتاب مراجيح الناثر بدر شاكر السيّاب
صدر عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» كتاب «مراجيح الناثر بدر شاكر السيّاب»، للكاتب الروائي جاسم المطير الذي حاول كشف «البيئة السياسية» التي أحاطت بالسيّاب، وجعلته يتأرجح باتجاهات شتّى ألحقت الضرر بسمعته الشخصية، وأساءت كثيراً إلى وضعه السياسي، وقناعاته الفكرية الرخوة التي أفضت إلى «انتهازيته» و«نفاقه الآيديولوجي».
يتألف الكتاب من مقدمة مستفيضه و14 مقالة، يردُّ فيها جاسم المطير على كتاب «كنتُ شيوعياً» للسياب، و«رسائل السياب» للكتاب ماجد السامرائي، كما تتشظى مادة الكتاب لتغطّي جانباً من السيرة الذاتية للشاعر، وسيرة المؤلف الذي تعرّف إلى السيّاب في الخمسينات، كما تعرّف في السبعينات إلى الشاعر عبد الوهاب البياتي الذي كان ينافس السيّاب على ريادة التجديد في الشعر العربي، إلى جانب نازك الملائكة.
يعترف المطير بأن مقالات هذا الكتاب لا علاقة لها بشعر السيّاب وشاعريته لأنه ترك هذه المهمة للنقاد والباحثين، وأعلنَ صراحة أنه لا يمتلك خبرة في هذا المضمار البعيد عن تخصصه السردي في كتابة القصة والرواية وأدب المذكرات، ولو بذل المطير جهداً مُضاعفاً لكتب سيرة ذاتية للسيّاب، بما لها من مزايا ومحاسن، وما عليها من مساوئ وأخطاء.
لا يعتمد المطير في كتابه على ذكرياته الشخصية فقط، وإنما يستعين بآراء كُتّاب وصحافيين آخرين، وأناس عاديين من كوادر الحزب الشيوعي العراقي، أمثال عبد الوهاب طاهر والصحافي عبّاس سكران وغيرهما الكثير. فقد حدّثه عبّاس أنّ السيّاب كتب قصيدة «أنشودة المطر» في «البيت الشيوعي» في الكويت، في أثناء إقامته هناك عام 1953. كما تطرّق إلى انعزاليته، وولعه بالقراءة، وتزايد اهتمامه بالأساطير التي كانت تغذّي مخيلته الشعرية المتوقدة. وقال الشاعر ألفريد سمعان: «إن أفضل قصائد السيّاب، من حيث الموضوع واللغة والثقافة، هي تلك التي كتبها عندما كان داخل قلعة الحزب الشيوعي العراقي، السياسية والثقافية»، وهو يعني «الأسلحة والأطفال» و«المومس العمياء» و«حفّار القبور». ومَنْ يقرأ هذه المجموعات الثلاث يشعر بقدرة السيّاب على ملامسة المعاناة الإنسانية لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.
ويرصد المطير المصادر الثقافية للسيّاب، فيعزوها إلى كُتّاب وشعراء بريطانيين وألمان وفرنسيين، أمثال شكسبير وإليوت وأيديث ستويل وغوته ورامبو وبودلير، وأنّ تلك القراءات هي التي صوّرت له أن التحرّر من الفكر الحزبي الملتزم هو الخلاص الذي يفضي به إلى الإبداع الحقيقي، بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تُغني عن جوع. أما بصدد مذكراته الحزبية - السياسية، فيعتقد المطير أنها «ذات صبغة عاطفية، غاضبة، سريعة، انتقامية، ثأرية، لا تحمل وضوح الفلاسفة والعلماء». كما يذهب أبعد من ذلك حين يقول: «إنها كُتبت بأسلوب نثري ضعيف، كما أجمع كثير من الذين قرأوها، بضمنهم شقيقه الأصغر مصطفى السيّاب».
ويُعيب عليه لجوئه إلى مؤسسة بنيامين فرانكلين الأميركية، التي ترجم لها كتابين مقابل 700 دينار عراقي، وهو مبلغ كبير جداً آنذاك. ويقول المؤلف إن السياب لم يعمل بمفرده على تشويه صورة الحزب الشيوعي العراقي، فقد كان أدونيس يلحُّ عليه لإرسال مُذكرات «كنتُ شيوعياً» كي ينشرها في كتاب ببيروت، كجزء ممنهج من عملية التشويه المتعمدة، علماً بأنّ أدونيس نفسه قد ترجم كتاب «التعذيب في سيبيريا».
ويعتقد المطير أن هجوم السيّاب على الحزب الشيوعي قد جاء لسببين لا ثالث لهما: الأول أنّ الحزب لم يمنحه الريادة في الشعر الحر، والأسبقية على نازك والبياتي، والثاني هو اعتقاده بتقصير الحزب في نشر وترويج قصائده الحرة، وانحيازه إلى شعراء عراقيين آخرين، مثل البياتي وبلند الحيدري، مع أنّ النقاد العراقيين، كما يذهب المطير، لم يروا أي فروق في ناحية التجديد الشعري بين الشعراء الثلاثة، ولم يكن للحزب أي دور في هذا التقييم النقدي، آخذين بنظر الاعتبار أن السيّاب هو الشاعر الوحيد الذي نال شهرة عراقية وعربية كبيرة بعد وفاته، وسوف يحقق الشاعر سعدي يوسف شهرة عربية - عالمية في أواخر التسعينات، حين عرّت قصائده ما يحدث من فظائع داخل «الغابة الفاشية» للديكتاتور، وحزبه القمعي الذي سلب حرية البلاد والعباد معاً.
يُركِّز المطير على ثلاثة شعراء مدّاحين، وهم الجواهري والسيّاب وعبد الرزاق عبد الواحد، فالأول مدح الملك فيصل الثاني لكنه استعاد ثقة المواطنين به، والسيّاب مدح الزعيم عبد الكريم قاسم يوم 7 فبراير (شباط) 1963 بقصيدة «أغثني يا زعيمي»، قبل الانقلاب بيوم واحد، لكنه تحول خلال 24 ساعة إلى مادحٍ للانقلابيين الطغاة، وأعلن عن خلاصه من الليل القاسمي الحالك السواد، وأنشد للبعثيين وغنّى لهم، لكنه سرعان ما تخلّى عن هذا الغناء لأنهم لم يقدموا له الأموال والعطايا كما كان يفعل «زعيمه العبقري الأوحد». أما عبد الرزاق عبد الواحد فقد ظل حزيناً على الديكتاتور، ووفياً له حتى بعد مماته، ولم يعتذر للعراقيين أبداً.
يمجّد المطير الشاعر التركي ناظم حكمت الذي تأثّر العراقيون والعرب به وبشعره، لأنه كان ثورياً مناوئاً للسلطة العسكرية القامعة في بلاده، وحينما زُجّ به إلى السجن، ارتفع صوت بابلو نيرودا مُطالباً بإطلاق سراحه، لكنه ما إن أُخلي سبيله حتى هرب إلى موسكو، وتحوّل إلى أسطورة حيّة تعيش في أذهان الناس. يخلص المطير إلى القول بأن واقع وخيال السيّاب لم يكونا ثوريين في التعبير الدائم عن مكامن البيئة - الثورية الشعبية العراقية.
ويؤكد المطير أن السيّاب لم يكن شاعراً مفكراً على غرار غوته، وقد برهن خلال عمره القصير (38 عاماً) على أنه «ليس شخصية فكرية - نضالية إلاّ بحدود». أما بصدد أحلام السيّاب فقد كانت كثيرة، من بينها اللجوء إلى موسكو، والحصول على شهادة الدكتوراه، وأن يجد حياته محمية في دولة متقدمة، لكنه كان بالفعل ذا حظ عاثر، فما أن هُرِّب إلى طهران على أمل المشاركة في مهرجان الشبيبة في بوخارست عام 1953 حتى اضطربت الأوضاع، فعاد إلى عبادان، ومنها إلى الكويت، ليجد نفسه في البيت الشيوعي ثانية، فكتب قصيدة «غريب على الخليج»، في جو من الانقطاع والعزلة، وكان يردد دائماً أن «الغربة دمار، وأنّ السجن أهون من الغربة»، ولم يستطع أن يحقق توازنه في بلدٍ ليس فيه مطر ولا شناشيل.
يصل المطير إلى نتيجة مفادها أن السيّاب لم يتعمّق بالمبادئ الشيوعية وأفكارها وخططها، ولم يقرأ جوانب النظرية الماركسية، وأن مقالاته الأربعين هي «محاولة فاسدة في الكتابة الفردية المتعالية على الجماعة الشيوعية... وتحريض على مساراتها النضالية».
وثمة إشارة مهمة إلى تلبية السيّاب لدعوة «خميس الشعر» ببيروت التي تحدّث فيها عن الدين كثيراً، كأنه يريد القول إنه ليس ملحداً، وقد قطع صلته بالحزب الشيوعي نهائياً. وقد قرأ في هذه الأمسية شعراً لمدة ساعتين متتاليتين، وبعدها قرّر قسم اللغة العربية في الجامعة الأميركية اعترافه بالشعر الحر، وإدخاله في مناهجها المستقبلية، حينها شعرَ «أنه إله الشعر العربي المتميز بالذكاء الخارق»، وأنّ قريته جيكور قد استردته من أيدي الشيوعيين الذين وصفهم بأوصاف شتى، أقلّها الإلحاد والإباحية والتبعية لموسكو.



