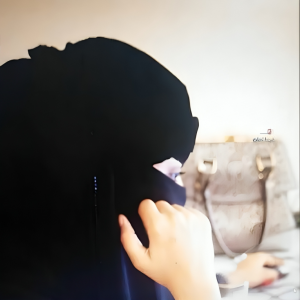حنين فضل تكتب لـ(اليوم الثامن):
من خوزستان إلى أصفهان.. لماذا أصبحت أزمة المياه اختباراً شرعياً للنظام الإيراني؟
تواجه إيران واحدة من أسوأ أزماتها البيئية منذ عقود، لكن ما يظهر كجفاف ونقص حاد في المياه تحوّل في الداخل إلى ملف سياسي يتجاوز البعد المناخي. فالمؤشرات البيئية التي تزداد سوءاً لم تعد تُقرأ فقط في سياق التغير المناخي العالمي، بل كامتداد مباشر لسياسات اتخذها النظام الإيراني خلال العقود الماضية، مستنداً إلى ما يعتبره مراقبون نهجاً يقوم على تحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات نفوذ داخلي واقتصادي وأمني.
وتشير شواهد عديدة إلى أن أزمة المياه ليست نتاجاً طارئاً للظروف الطبيعية. فمع تراجع الأمطار وتوسع التصحر، ظلّت مشروعات السدود ونقل المياه تتواصل بوتيرة متسارعة، رغم التحذيرات العلمية. وتحوّلت عملية إدارة الموارد إلى شبكة مصالح اقتصادية وأمنية مرتبطة بمؤسسات نافذة داخل الدولة، ما جعل القرارات المتعلقة بالمياه خاضعة لمعادلات سياسية لا لمعايير بيئية أو علمية.
وتبرز في هذا السياق الشركات التابعة للحرس الثوري باعتبارها لاعباً أساسياً في مشروعات البنية المائية. فمقر “خاتم الأنبياء” وشركات مرتبطة به سيطرت على قطاع السدود ونقل المياه، فيما وُصفت العملية من قبل خبراء بأنها توسع اقتصادي على حساب التوازن البيئي. وقد أسهمت هذه المشاريع في تغيير دورة المياه الطبيعية وإضعاف قدرة المناطق الريفية على الصمود أمام الجفاف، الأمر الذي دفع أقاليم واسعة إلى الانهيار البيئي.
محافظة خوزستان تقدم المثال الأكثر وضوحاً على هذا المسار. فبناء سد “غُتوند” فوق طبقات ملحية رغم اعتراض المتخصصين أدى إلى ارتفاع حاد في ملوحة نهر كارون وتدمير مساحات زراعية واسعة كانت تعتمد عليه. وتراجع مستوى المياه في الأهوار الجنوبية التي لعبت دوراً بيئياً حيوياً لقرون، فيما ازدادت العواصف الترابية وأصبحت الهجرة الداخلية مساراً إلزامياً لآلاف العائلات. ووفق تقديرات محلية، فقدت عشرات القرى مواردها الزراعية بالكامل خلال سنوات قليلة نتيجة القرارات المتعلقة بالمشروعات المائية.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة المناطق الزراعية على البقاء، واصلت الحكومة توجيه المياه إلى مجمعات صناعية ضخمة للصلب والبتروكيماويات شُيّدت في مناطق شحيحة المياه. وبحسب اقتصاديين إيرانيين، أنشئت هذه الصناعات بهدف دعم اقتصاد موازٍ مرتبط بالحرس الثوري وتوفير مصادر تمويل خارج الموازنة الرسمية. وتشير الدراسات إلى أن هذه المنشآت تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه في البلاد، رغم وجودها في بيئة صحراوية لا تتحمل الأنشطة الصناعية الثقيلة.
هذا التحول لم ينعكس على الزراعة فحسب، بل غيّر البنية الاجتماعية لمناطق واسعة. ففي أصفهان وخوزستان ويزد، تظهر حقول جافة كانت خصبة قبل سنوات قليلة. وانخفضت قدرة المزارعين على الاستمرار في مهنهم مع تراجع المياه الجوفية، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة نحو المدن الكبرى بحثاً عن مصادر دخل بديلة. ومع تفاقم الوضع، ظهرت احتجاجات في أكثر من منطقة، أبرزها مظاهرات المزارعين في أصفهان وخوزستان عام 2021، التي اعتُبرت أول موجات احتجاج واسعة مرتبطة مباشرة بندرة المياه.
وردّت السلطات على هذه المظاهرات بأسلوب أمني قاسٍ، شمل استخدام الذخيرة الحية وتوقيف متظاهرين وناشطين. ووصفت وسائل إعلام رسمية آنذاك تحركات المحتجين بأنها محاولات “لاستغلال الأزمة لصالح أطراف خارجية”، فيما اعتبرت مجموعات حقوقية أن الاحتجاجات كانت تعبيراً عن أزمة معيشية لا تتحمل مزيداً من التأجيل.
ورغم الخطاب الرسمي الذي يحمّل المناخ مسؤولية الأزمة، صدرت خلال السنوات الأخيرة اعترافات من مسؤولين تشير إلى أن المشكلة تتجاوز العوامل الطبيعية. ففي أغسطس 2024، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن توسع البلاد العمراني جرى “دون تخطيط”، وإن الاعتماد المفرط على الآبار العميقة يهدد مستقبل مدن رئيسية مثل طهران وكرج. وأضاف أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى نفاد مصادر المياه الجوفية بصورة “لا يمكن تداركها”.
وتُظهر تقارير هندسية أن بعض مناطق العاصمة تشهد هبوطاً أرضياً بمعدلات مقلقة نتيجة استنزاف المياه الجوفية، ما يشكل تهديداً للبنية التحتية وللاستقرار السكاني. وترى منظمات معنية بالبيئة أن المشكلة مرشحة للتصاعد في حال استمرار النمو العمراني واستهلاك المياه بالوتيرة الحالية.
وتعتبر مجموعات معارضة، بينها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الأزمة ناتجة عن سياسات “ممنهجة”، وليست نتيجة خلل إداري عابر. ووفق تقديراتها، فإن شبكة المصالح المرتبطة بقطاع المياه تمثل أحد أركان النظام الاقتصادي الذي يدعم مؤسسات قوية في الدولة، ما يجعل إصلاح هذا القطاع مرهوناً بإصلاحات سياسية واسعة تتجاوز البعد الفني.
وتشير تقارير دولية إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة لسياسات المياه، بما يشمل خفض عدد السدود، وإعادة النظر في مواقع المشاريع الصناعية الثقيلة، وتطوير منظومات للري المستدام، وإعادة تأهيل الأهوار والأنهار التي تضررت خلال العقود الماضية. لكن هذه المقترحات لا تزال تواجه عقبات سياسية وإدارية، خصوصاً مع تداخل المصالح الاقتصادية والأمنية في ملفات المياه.
ويزيد من تعقيد الوضع أن شح المياه بات مرتبطاً بشكل مباشر بأزمات اقتصادية أوسع. فارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة، وتقلص القطاع الزراعي، كلها عوامل تُضعف قدرة السكان على تحمل تكاليف الأزمة. وتشير دراسات محلية إلى أن بعض المناطق مهددة بفقدان مواردها بالكامل خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم تبني سياسات متوازنة للمياه.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الضغوط البيئية والاجتماعية، يواصل النظام تحميل الطبيعة المسؤولية. ويؤكد مسؤولون أن التغير المناخي العالمي وتراجع الهطول المطري هما سبب الأزمة الرئيسي، فيما يرى خبراء أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة لا يفسر العجز الحاصل في بعض الأقاليم التي تعرضت لعمليات نقل مياه مكثفة، أو تلك التي أُقيمت فيها مشاريع صناعية تفوق قدرة المنطقة البيئية.
وبحسب باحثين في قضايا البيئة الإيرانية، فإن الأزمة لم تعد قابلة للفصل عن بنية الحكم. فالمياه باتت جزءاً من إدارة السلطة، والقرارات المتعلقة بها تُبنى وفق اعتبارات سياسية واقتصادية تتجاوز ما تحتاجه المناطق المتضررة. ويؤكد هؤلاء أن أي تحسن محتمل يعتمد على قدرة الدولة على فصل إدارة الموارد عن شبكات النفوذ الاقتصادي، وتبنّي سياسات شفافة تتوافق مع طبيعة البلاد الجغرافية.
وتبدو الأزمة في جوهرها أزمة ثقة بين المجتمع والدولة، حيث يشير السكان في المناطق المتضررة إلى أن توزيع المياه يتم بطريقة غير عادلة، وأن بعض الأقاليم لا تحصل على حصتها الطبيعية. ومع تكرار حالات الجفاف وتراجع مستوى الأنهار، تتصاعد المخاوف من أن يؤدي العجز المائي إلى موجات نزوح جديدة وتوترات اجتماعية في مناطق تعتبر أصلاً من بين الأكثر هشاشة اقتصادياً.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل مستقبل المياه في إيران مرتبطاً بنمط الحكم الاقتصادي والسياسي أكثر من ارتباطه بالعوامل المناخية وحدها. فالأزمة الحالية تعكس تراكمات لقرارات اتخذت خلال أربعة عقود، واستخداماً واسعاً للموارد بما يخدم قطاعات محددة على حساب الأمن البيئي للمجتمع. ورغم اعتراف بعض المسؤولين بتفاقم الوضع، لا تبدو في الأفق خطة شاملة تعالج جذور الأزمة أو تعيد التوازن إلى النظام المائي في البلاد.
ومع استمرار الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، تواجه إيران اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على إدارة مورد يعتبر أساسياً لأمنها واستقرارها. وإذا لم تُراجع السياسات الحالية، قد تتحول الأزمة إلى تحدٍ وجودي يهدد قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع، في بلد يواجه أصلاً ضغوطاً اقتصادية وسياسية متصاعدة.