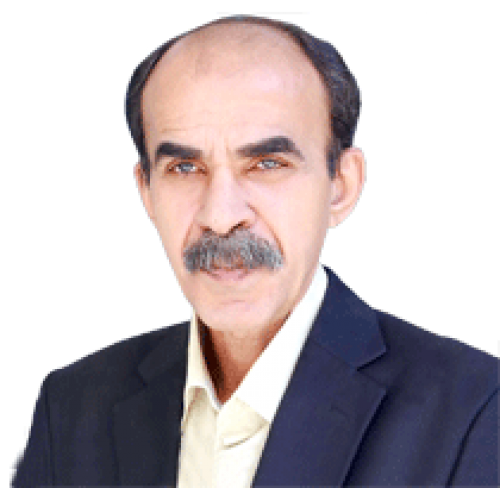وارد بدر السالم يكتب:
تأملات في تفاوت السرد الجندري العربي بين الذكر والأنثى
الكثير من القضايا الأدبية التي تنتهج التقسيم الجنسي بين الرجل والمرأة هي في الواقع قضايا مفتعَلة، لا تخدم الأدب ولا القضايا الاجتماعية الراهنة بل هي ابتعاد عن التفكير العميق والعمل الجمالي، ينشأ من استيعاب مغلوط للمفاهيم.
كثيرٌ من الكتابات السردية التي تكتبها المرأة يكون الرجل فيها على هامش الكتابة أو ثانويَّ الشخصية على نحوٍ ما، على أن تكون المرأة السردية هي المحور الأساسي فيها.
وربما يصحُّ هذا على الرجل/ الكاتب الذي يتقصى شخصياته الذكورية أكثر من تقصيه للشخصيات الأنثوية بوصفه فحل الكتابة، وتكون المرأة في طوق الأجواء الرجولية إلى حد بعيد. فنوال السعداوي وغادة السمان تمحورت كتاباتهما وأفكارهما حول المرأة من دون الحاجة إلى وجود الرجل إلا للتعريف بدوره الحياتي أو الذكوري وما يتطلبه هذا التعريف من مفاصل اجتماعية.
بين المرأة والرجل
نعتقد أن المرأة الغربية/ الكاتبة، بسبب توافر المناخ الاجتماعي الملائم واعتدال النظرة الاجتماعية للمرأة، تخطّت هذه العتبة الضيقة وكتبت عن الرجل، أمثال ناتالي ساروت وإليزابيث دورا وسيمون دي بوفوار وأخريات. حيث نجد تماثلا جندريا في مثل هذه الكتابات ويكون الرجل هو القامة الطويلة في سرديات النساء.
ومثل هذا الجندر؛ اصطلاحا ومعنى؛ قد يكون ملتبسا بعض الشيء كمفهوم اجتماعي قبل أن يكون أدبيا. لكن وفي اجتياز هذه المحنة الكتابية في جندرية السرد العربي نتماثل مع مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي الذي يختلط عادة بمفهوم الجنس ذائع الصيت في الكتابات العربية القديمة والحديثة.

الجنس ليس هو الجندر. وكثيرا ما تختلط علينا المفاهيم الجديدة والمصطلحات النقدية والاجتماعية التي تتوخى تحديد الحالات الاجتماعية ومناقشتها. فالأول هو عضوي واحتياج بيولوجي فطري وغريزي يتطلب ثنائية الذكر والأنثى ويُعرّف بهما حفاظا على النوع البشري. والآخر هو النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالجنوسة كصفات اجتماعية فارقة بين الذكر والأنثى من الناحية الثقافية ليكون هو الهوية الجندرية/ الجنوسية لكل من الجنسين؛ كبِنية اجتماعية من المعتقدات والقيم والثقافات والصور والمعارف والخبرات والعلوم والخصائص والأعراف والمكتسبات الثقافية والأنشطة العامة، بما يعزز قوة الذكورة أو الأنوثة من الجوانب الاجتماعية في أقل تقدير، ولا علاقة للجنس بهذه الأدوار المتضامنة.
إن الجندر هو الهوية الشخصية للأنثى مثلما هي للذكر؛ تُفسّر على أنها الهوية التي ترسمها ظروف المجتمعات في تحضرها أو تخلفها، بما فيها من بنى وأدوار اجتماعية متباينة بين الاثنين. لذلك سنجد انعكاس مثل هذا الافتراق على الكتابة الشخصية للمرأة والرجل معا. والميل إلى الهوية الجندرية الشخصية أكثر من الميل إلى الهوية الشخصية الجندرية للآخر. أي أن الكاتب أو الكاتبة يعملان بصفاتهما الشخصية الاجتماعية من دون أن يتمثلا صفات الآخر الداخلية والسيكولوجية في فهم المتن الشخصي لكل منهما. وهذه الصفات التي تنمو زمنيا في الحاضنة الاجتماعية قد تتغير بحسب الظروف المحيطة بها وبالتالي هي مكتسبة اجتماعيا. بمعنى أن الكاتبة العربية على وفق جندريتها تغذّي كتاباتها من هذا المفهوم الاجتماعي وتعكسه أدبيا على كتاباتها، فهي ترى أنها الأقدر على موازنة هذه الجوانب الشخصية في الأنثى أكثر من الرجل.
ويرى الرجل أنه الأكثر إلماما ببحث سيكولوجية الذكر السردي أكثر من المرأة. وفي هذا التباين سنجد ما يشبه العزلة والتباعد بين الاثنين، حتى شاعت تسميات مثل “أدب المرأة” و”الكتابة النسوية”، كتسميات تفرّق بين النوعين من الكتابة. وهو شيوع قد يكون له ما يبرره في البحث الأكاديمي أحيانا. وقد يكون نقديا في معظم الحالات. على أن مثل هذه التسميات وإن بقيت إلى اليوم شاخصة في السلوك النقدي، لكنها لم تستطع إيجاد مخرجات نقدية واضحة وهي تؤسس مفاهيمها عن سلطة الجندرية العربية في علاقات الكتابة الأدبية والبحثية.
تفاوت جندري
غالبا ما يكون الجنس متداخلا مع هذه المفاهيم الجديدة التي خرجت من العباءة الاجتماعية أكثر مما خرجت من عباءة الأدب، لتكون دالّة على مفهوم يومي حياتي يستعين بثقافة المجتمع واتساع بياناته الإيجابية والسلبية.
نجد أن العلاقات النفسية والبيولوجية بين الكاتب/ الكاتبة في المجتمع العربي مفهومة إلى حد واضح، ومن هذا فإن موضوعة الجندر في السرديات العربية وفي شرق الكتابة المتوسطية تكاد تكون مفردة وغير جريئة؛ ولاسيما عند المرأة التي تستعين بالكتابة وتستجيب لها في ظروف خاضعة إلى محدّدات اجتماعية قارّة لا يمكن تخطيها إلا في ما ندر. وحتى الجرأة النسوية في الكتابة سيقف بينها وبين الكاتبة أكثر من عقدة صريحة مهما كان النوع الاجتماعي النسوي حرا ومشاكسا لثوابت المجتمع، لكنه بالنتيجة سيتلكأ من دون أن يفصح كثيرا عن ماهيته الأدبية في النوع الثقافي الذي يمتلكه وما هو عليه.
غنام غنام اتخذ من وقائع الاحتلال أداة يوصلها في شكل مباشر أو غير مباشر إلى المتلقي عن طريق التغريب
في فحص الكتابات النسوية العربية انطلاقا من هذا المفهوم سنجد الأنوثة هي التي تطغى وفقا لمفهوم الجندرية في النوع الاجتماعي. ما يفسر الكثير من حقيقة المجتمع العربي من وجهة النظر النسوية، كما يفسر الكثير من الشؤون الذاتية للمرأة ويقف على تفاصيل مهمة قد لا يستوعب الرجل كتابتها في مشكلة الاتصال والتواصل النفسي وحتى البيولوجي منه، والذي يقف حاجزا في أن يكون الاثنان على خط مشروع واحد. وهو أمر يمكن تحرّيه في الكتابات النسوية على وجه التحديد.
ويُحتمل عكس الأمر من هذه النواحي التي نجد فيها تفاوتا بيّنا بين ذكورة السرد وأنوثته وما يحملانه من قيم وأفكار وتقاليد وطقوس ومعارف وعلوم وثقافات حتى لو كان المنشأ واحدا والجغرافية ذاتها والزمن نفسه هو الذي يجري بينهما.
إن مثل هذا التفاوت الجندري العربي طبيعي في مجتمع واسع الجغرافيا بخلفيات أيديولوجية ودينية متطرفة وسياسات متفاوتة وثقافات ناضجة وغير ناضجة، مما يعني أن للمرأة/ الكاتبة شخصية أخرى غير شخصيتها الاجتماعية في مستويات وعي الكتابة. وهذا يشمل الذكر/ الكاتب أيضا.