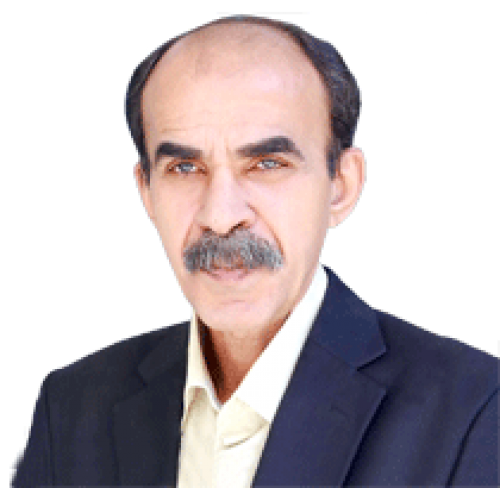وارد بدر السالم يكتب:
أدب الحريات الوطنية
يوم كانت طائرات الحلفاء تلقي بقصيدة “الحرية” إبان الحرب العالمية الثانية للتحريض على المقاومة والقتال والصمود بوجه الألمان، كان الشعر أحد وسائل المقاومة وبث روح الحماسة في نفوس المقاتلين. وكان بول إيلوار صاحب القصيدة لم يكتشف شيئاً جديداً، لكنه ابتكر اللحظة التعبوية الملائمة بهذا الإشهار واسع النطاق على جبهات القتال في استقدام المعنى بشموليته الذي وصفته القصيدة لتذكير الجنود بيوميات صغيرة تتجمع لتكون هي الوطن الحر. وأن الهوامش الصغيرة المعتادة هي المتن الأكبر الذي يشكّل الوجود الإنساني. وهي الجوهر الذي ينبغي الدفاع عنه باستماتة. وهذا النوع التحريضي المباشر من الكتابات في الأزمات الوطنية الساخنة له فعل مؤثر عندما تكون الكلمة قوية بفعل الرصاصة، وعاملاً قوياً للحث على الصمود والاستبسال والمقاومة.
وفي الأدب العربي لنا أمثلة وفيرة على شعر المقاومة وأدب الحريات الذي رافق أجيالاً متعاقبة؛ وليس لنا أن نتجاوز الشاعر الراحل محمود درويش في مجمل قصائده الكبيرة التي تعطي للحرية العربية نكهة وطنية خاصة (لو كان حراً لما صار أسطورة) فالحرية ليست هبة. وأسطورتها من أنها صناعة بشرية وليست وصفاً إنشائياً تلجأ الشعوب إليه عندما تحتاجها. وأنْ تصنع الحرية أفضل من أن تطلبها. وصناعة الحرية تكلف الشعوب خسائر باهظة حينما تلجأ إلى الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية وحتى المواجهات المسلحة كآخر الحلول الصعبة. ومن هذه المعطيات يظهر الناشطون والأدباء الوطنيون والسياسيون والجماليون بشكل عام، ليؤرّخوا لهذا الحراك كتابةً ومواقفَ وشهاداتٍ ويتركونه في أرشيف التاريخ الإنساني مع حركة الزمن الجارية.
الحرية الجماعية نتاج التلاقي الفردي للخروج من دائرة الخوف وتفعيل الجانب العقلي المطالب بالديمقراطية السياسية التي هي شكل واسع من أشكال الحريات المجتمعية المعنوية
وقد وقف نيلسون مانديلا على هذه المعاني بوصفه أشهر سجين سياسي قائلاً إن العبيد فقط يطلبون الحرية أما الأحرار فيصنعونها، ولهذا نجد الحريات المنتزعة من السلطات الشمولية تصنع الأبطال والشهداء والشعراء والمبدعين والقادة الكبار والسياسيين الوطنيين، مثلما نجد أن معظم الأدباء يقفون في الصفوف الأولى من هذه القضية للدفاع عنها وتنوير الأجيال إلى ضرورة الوقوف ضد الحكّام الفاسدين والسياسيين النفعيين وسلطات الدم والظلم، وحتى في الحروب الوطنية هناك أصوات تتعالى لشعراء وروائيين للحث على مواجهة أعداء الوطن. فالأوطان الحقيقية هي القادرة على أن تعيش بأمان وسلام وحريات مفتوحة ضمن مساحاتها الاجتماعية والأخلاقية.
درويش وإيلوار أنموذجان شعريان لأدب المقاومة والبحث عن الحريات الوطنية. ولنا في السرد نماذج أدبية صارت علامات في أدب الحريات والمقاومة، فلا يمكن أن نستغني عن ذكر الروائي فيركور في روايته القصيرة “صمت البحر” التي نشرت سراً في باريس إبان الاحتلال النازي لتصبح رمزا للمقاومة، ليشكل مع مواطنه إيلوار ثنائياً في الشعر والسرد ضد المحتل الغاصب. وقد يكون الأدب العربي متردداً بهذا الخصوص لأسباب تاريخية معروفة، لكنه مواكِب بشكل عام لآليات التغيير السياسية ومرافِق للحراك الثوري على مدار العقود التي مضت، لاسيما في الشعر الوطني المحرّض على انتزاع الحريات من السلطات الشمولية.
إنّ هذا التذكر وما سيليه من استشهادات اسمية سينقلنا عبر تاريخ أدب الحريات القديم والحديث، فأن تسعى لصناعة الحرية يعني أن تسعى لصناعة الحياة من جديد. وستبدو الحالة صورة مكبّرة في جماعيتها أكثر من فرديتها، فالتحرر من قيد السلطة بهذه الصيغة هو الذي يؤلّب على الثورات والتظاهرات والتمرد الإيجابي ويغذّي روح الوطنية إلى أقصى عمقها، لذا نرى في قول جورج صاند “صناعتي هي الحرية” ما يمكن فهمه أن الأدب بشتى أجناسه صانع آخر يتدخل في الحراك الشعبي العام، ويضفي عليه هالة جمالية مساوية له في القيمة الثورية، وصولاً إلى ممارسة الحرية من أوسع أبوابها.
“علينا أن نكون أحراراً ليس فقط لأننا نعلن الحرية بل لأننا نمارسها” وهذه الممارسة؛ وهي بتعبير وليم فوكنر، هي الهدف الأخير لانتزاع الحقوق الجماعية للشعوب من طغاة السلطة وحكّامها والمتسيدين على مقدراتها، فالفضيلة الكبرى ليس أن تكون حراً وإنما في أن تناضل من أجل الحرية كما يرى نيكوس كازانتاكيس، وحتى نزار قباني في رومانسياته المباشرة قال “إلا أني لم أتزوج بين نساء العالم إلا الحرية” لذلك فالنضال من أجل الحرية -عربياً في الأقل- هو إيجاد مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي عادل بموجب احتواء الأزمات والخروج من البنى الاجتماعية غير المتطورة بعقلانية والتحرر من أشكال العقائد المفروضة والمهيمنات الغريبة والدخيلة بما فيها الدينية المتطرفة، فالحرية الشخصية فطرة بشرية.
صناعة الحرية تكلف الشعوب خسائر باهظة حينما تلجأ إلى الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية وحتى المواجهات المسلحة كآخر الحلول الصعبة
والحرية الجماعية نتاج هذا التلاقي الفردي للخروج من دائرة الخوف وتفعيل الجانب العقلي المطالب بالديمقراطية السياسية التي هي شكل واسع من أشكال الحريات المجتمعية المعنوية، بما فيها من تفعيل الحياة السياسية والاقتصادية والسيكولوجية، بعيداً عن أمراض السياسة القمعية ومشتقاتها التي نعرفها في حياتنا العربية. وهذا ما تصل القصائد إليه والسرديات الكبرى التي تنادي بالخروج من بيئة غير ناضجة إلى بيئة أكثر نظافة وتحضراً. فالتاريخ العربي المعاصر حافل بأدب الحريات.
من صرخات درويش المدوّية وفدوى طوقان حتى العقاد والرصافي والزهاوي والشافعي وأحمد شوقي وكل الشعراء الذين عاصروا الثورات العربية ومنقلبات السياسة والاحتلالات الأجنبية كان للأصوات الشعرية ميزاتها المتفوقة، يتبعها السرد ولو كان أقل جرأة من الشعر لأن الاستيعاب الزمني ليس في صالحه عموماً، ولهذا حتى وأننا نقلّب في التاريخ العربي البعيد لا تخذلنا الأمثلة الأدبية؛ الشعرية منها على وجه الخصوص، في معالجة موضوع الحرية والتحرر من العبودية سواء أكانت عبودية فردية أم جماعية وقد تقاسمها شعراء كبار كالمتنبي وبشار بن برد والشريف المرتضى وعبدالله بن أُبَي وابن الرومي وأبوتمام ودعبل الخزاعي والأصمعي.. وآخرون كثيرون ترجموا أزمان العبودية الماضية